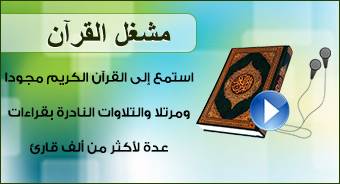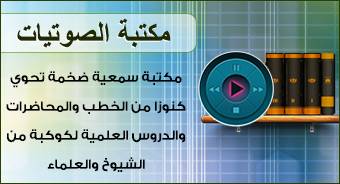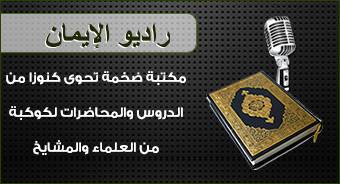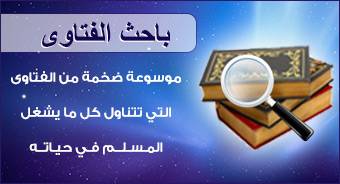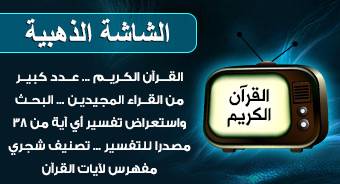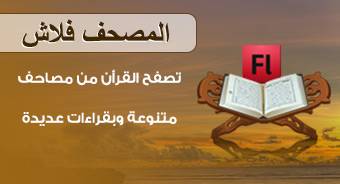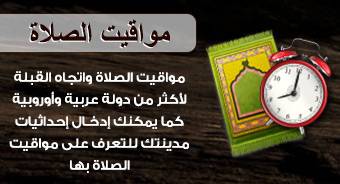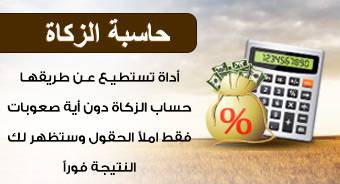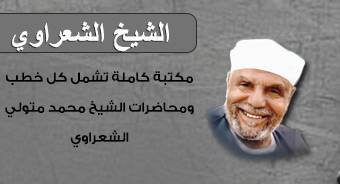|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وقوله: وقد سمع بعض الأعراب الجفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية فقال ما أفصح ربك يا محمد وإذا اعتبر التنوين في مكرا للتفخيم زاد أمر المبالغة في مكرهم أي كبيرا في الغاية وذلك احتيالهم في الدين وصدهم للناس عنه وإغراءهم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام وقرأ عيسى وابن محيصن وأبو السمال {كبارا} بتخفيف الباء وهو بناء مبالغة أيضا إلا أنها دون المبالغة في المشدد ومثل كبار في ذلك حسان وطوال وعجاب وجمال إلى ألفاظ كثيرة وقرأ زيد بن علي وابن محيصن فيما روى عنه وهب بن واضح {كبارا} بكسر الكاف وفتح الباء قال ابن الأنباري: هو جمع كبير كأنه جعل مكرا مكان ذنوب أو أفاعيل يعني فلذلك وصف بالجمع {وقالواْ لا تذرُنّ ءالِهتكُمْ} أي لا تتركوا عبادتها على الإطلاق إلى عبادة رب نوح عليه السلام {ولا تذرُنّ ودّا ولا سُواعا ولا يغُوث ويعُوق ونسْرا} أي ولا تتركوا عبادة هؤلاء خصوها بالذكر مع اندراجها فيما سبق لأنها كانت أكبر أصنامهم ومعبوداتهم الباطلة وأعظمها عندهم وإن كانت متفاوتة في العظم فيما بينها بزعمهم كما يومئ إليه إعادة لا مع بعض وتركها مع آخر وقيل أفرد يعوق ونسر عن النفي لكثرة تكرار لا وعدم اللبس وقد انتقلت هذه الأصنام إلى العرب أخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح عليه السلام في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع وكانت هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فعلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ودرس العلم عبدت وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب القرظي أنه قال كان لآدم عليه السلام خمسة بنين ود وسواع إلخ فكانوا عبادا فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزنا شديدا فجاءهم الشيطان فقال حزنتم على صاحبكم هذا قالوا نعم قال هل لكم أن أصور لكم مثله في قبلتكم إذا نظرتم إليه ذكرتموه قالوا نكره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئا نصلي عليه قال فاجعله في مؤخر المسجد قالوا نعم فصوره لهم حتى مات خمستهم فصور صورهم في مؤخر المسجد فنقصت الأشياء حتى تركوا عبادة الله تعالى وعبدوا هؤلاء فبعث الله تعالى نوحا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادتها فقالوا ما قالوا.وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أن ودا كان أكبرهم وأبرهم وكانوا كلهم أبناء آدم عليه السلام.وروي أن ودا أول معبود من دون الله سبحانه وتعالى أخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر قال ذكروا عند أبي جعفر رضي الله تعالى عنه يزيد بن المهلب فقال أما أنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله تعالى ثم ذكر ودا وقال كان رجلا مسلما وكان محببا في قومه فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم تشبه في صورة إنسان ثم قال أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به قالوا نعم فصور لهم مثله فوضعوه في ناديهم فجعلوا يذكرونه به فلما رأى ما بهم من ذكره قال هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل رجل منكم تمثالا مثله فيكون في بيته فيذكر به فقالوا نعم ففعل فأقبلوا يذكرونه به وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله تعالى فكان أول من عبد غير الله تعالى في الأرض ودا.وأخرج ابن المنذر وغيره عن أبي عثمان النهدي أنه قال رأيت يغوث وكان من رصاص يحمل على جمل أجرد ويسيرون معه لا يهيجونه حتى يكون هو الذي يبرك فإذا برك نزلوا وقالوا قد رضي لكم المنزل فينزلون حوله ويضربون عليه بناء.وقيل يبعد بقاء أعيان تلك الأصنام وانتقالها إلى العرب فالظاهر أنه لم يبق إلا الأسماء فاتخذت العرب أصناما وسموها بها وقالوا أيضا عبد ود وعبد يغوث يعنون أصنامهم وما رآه أبو عثمان منها مسمى باسم ما سلف ويحكى أن ودا كان على صورة رجل وسواعا كان على صورة امرأة ويغوث كان على صورة أسد ويعوق كان على صورة فرس ونسرا كان على صورة نسر وهو مناف لما تقدم أنهم كانوا على صور أناس صالحين وهو الأصح وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة بخلاف عنهم {ودا} بضم الواو وقرأ الأشهب العقيلي {ولا يغوثا ويعوقا} بتنوينهما قال صاحب اللوامح جعلهما فعولا فلذلك صرفهما وهما في قراءة الجمهور صفتان من الغوث والعوق يفعل منهما وهما معرفتان فلذلك منعا الصرف لاجتماع الثقيلين اللذين هما التعريف ومشابهة الفعل المستقبل وتعقبه أبو حيان فقال هذا تخبيط أما أولا فلا يمكن أن يكونا فعولا لأن مادة يغث مفقودة وكذلك يعق وأما ثانيا فليسا بصفتين لأن يفعلا لم يجئ اسما ولا صفة وإنما امتنعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل إن كانا عربيين وللعلمية والعجمة إن كانا عجميين وقال ابن عطية قرأ الأعمش {ولا يغوثا ويعوقا} بالصرف وهو وهم لأن التعريف لازم وكذا وزن الفعل وأنت تعلم أن الأعمش لم ينفرد بذلك وليس بوهم فقد خرجوه على أحد وجهين أحدهما: أن الصرف للتناسب كما قالوا في {سلاسلا وأغلالا} [الانسان: 4] وهو نوع من المشاكلة ومعدود من المحسنات وثانيهما: أنه جاء على لغة من صرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب وذلك لغة حكاها الكسائي وغيره لكن يرد على هذا أنها لغة غير فصيحة لا ينبغي التخريج عليها.{وقدْ أضلُّواْ} أي الرؤساء {كثِيرا} خلقا كثيرا أي قبل هؤلاء الموصين بأن يتمسكوا بعبادة الأصنام فهم ليسوا بأول من أضلوهم ويشعر بذلك المضي والاقتران بقد حيث أشعر ذلك بأن الإضلال استمر منهم إلى زمن الإخبار بإضلال الطائفة الأخيرة وجوز أن يراد بالكثير هؤلاء الموصين وكان الظاهر وقد أضل الرؤساء إياهم أي الموصين المخاطبين بقوله: {لا تذرن آلهتكم} فوضع كثيرا موضع ذلك على سبيل التجريد وقال الحسن وقد أضلوا أي الأصنام فهو كقوله تعالى: {ربّ إِنّهُنّ أضْللْن كثِيرا مّن الناس} [ابراهيم: 36] وضمير العقلاء لتنزيلها منزلتهم عندهم وعلى زعمهم ويحسنه على ما في (البحر) عود الضمير على أقرب مذكور ولا يخفى أن عوده على الرؤساء أظهر إذ هم المحدث عنهم والمعنى فيهم أمكن والجملة قيل حالية أو معطوفة على ما قبلها وقوله تعالى: {ولا تزِدِ الظالمين إِلاّ ضلالا} قيل عطف على {رب أنهم عصوني} [نوح: 21] على حكاية كلام نوح عليه السلام بعد قال والواو النائبة عنه ومعناه قال: رب إنهم عصوني وقال: {لا تزد} إلخ أي قال هذين القولين على أن الواو من كلام الله تعالى لأنها داخلة في الحكاية وما بعدها هو المحكي وإليه ذهب الزمخشري وإنما ارتكب ذلك فرارا من عطف الإنشاء على الخبر وقيل عطف عليه والواو من المحكي والتناسب إنشائية وخبرية غير لازم في العطف كما قاله أبو حيان وغيره وفيه خلاف وفي (الكشف) لك أن تجعله من باب {واهجرني مليا} [مريم: 46] أي فاخذلهم ولا تزدهم وفي العدول إلى الظالمين إشعار باستحقاقهم الدعاء عليهم وإبداء لعذره عليه السلام وتحذير ولطف لغيرهم وفيه أنه بعض ما يتسبب من ساويهم وهو معنى حسن فعنده العطف على محذوف إنشائي ولعل الأولى أن يقال إن العطف على {رب إنهم عصوني} والواو من المحكي والتناسب حاصل وقال الخفاجي الظاهر أن الغرض من قول: {رب إنهم} إلخ الشكاية وإبداء العجز واليأس منهم فهو طلب للنصرة عليهم كقوله: {رب انصرني بما كذبون} [المؤمنون: 26] ولو لم يقصد ذلك تكرر مع ما مر منه عليه السلام فحينئذٍ يكون كناية عن قوله اخذلهم أو انصرني أو اظهر دينك أو نحوه فهو من عطف الإنشاء على الإنشاء من غير تقدير ويشهد له أن الله تعالى سمى مثله دعاء حيث قال سبحانه: {فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون} [الدخان: 22] فتدبر وهو حسن خال عن التكلف وارتكاب المختلف فيه إلا أن في الشهادة دغدغة والمراد بالضلال المدعو بزيادته أما الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم فيكون ذلك دعاء عليهم بعدم تيسير أمورهم وأما الضلال بمعنى الهلاك كما في قوله تعالى: {إِنّ المجرمين في ضلال وسُعُرٍ} [القمر: 47] وهو مأخوذ من الضلال في الطريق لأن من ضل فيها هلك فيكون المعنى أهلكهم وفسره ابن بحر بالعذاب وهو قريب مما ذكر وقيل هو على ظاهره أعني الضلال في الدين والدعاء بزيادته إنما كان بعد ما أوحي إليه عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ومآله الدعاء عليهم بزيادة عذابهم ويحتاج إلى دليل وبما سمعت ينحل ما يقال أن طلب الضلال ونحوه إما غير جائز مطلقا أو إذا دعى به على وجه الاستحسان وبدونه وإن كان جائزا لكنه غير ممدوح ولا مرضي فكيف دعا بذلك نوح عليه السلام عليهم.{مّمّا} أي من أجل خطيآتهم {خطيئاتهم أُغْرِقُواْ} بالطوفان لا من أجل أمر آخر فمن تعليلية وما زائدة بين الجار والمجرور لتعظيم الخطايا في كونها من كبائر ما ينهى عنه ومن لم ير زيادتها جعلها نكرة وجعل {خطيئاتهم} بدلا منها وزعم ابن عطية أن من لابتداء الغاية وهو كما ترى وقرأ أبو رجاء {خطياتهم} بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء وقرأ الجحدري وعبيد عن أبي عمرو {خطيئتهم} على الإفراد مهموزا وقرأ الحسن وعيسى والأعرج بخلاف عنهم وأبو عمرو {خطاياهم} جمع تكسير وقرأ عبد الله {من خطيآتهم ما أغرقوا} بزيادة {ما} بين {خطيآتهم} و{أغرقوا} وخرج على أنها مصدرية أي بسبب خطيآتهم إغراقهم وقرأ زيد بن علي {غرقوا} بالتشديد بدل الهمزة وكلاهما للنقل {فأُدْخِلُواْ نارا} هي نار البرزخ والمراد عذاب القبر ومن مات في ماء أو نار أو أكلته السباع أو الطير مثلا أصابه ما يصيب المقبور من العذاب وقال الضحاك كانوا يغرقون من جانب ويحرقون بالنار من جانب وأنشد ابن الأنباري: ويجوز أن يراد بها نار الآخرة والتعقيب على الأول ظاهر وهو على هذا لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال فكأنه شبه تخلل ما لا يعتد به بعدم تخلل شيء أصلا وجوز أن تكون فاء التعقيب مستعارة للسببية لأن المسبب كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانع وتنكير النار إما لتعظيمها وتهويلها أو لأنه عز وجل أعد لهم على حسب خطيآتهم نوعا من النار ولا يخفى ما في أغرقوا فادخلوا نارا من الحسن الذي لا يجارى ولله تعالى در التنزيل {فلمْ يجِدُواْ لهُمْ مّن دُونِ الله أنصارا} أي فلم يجد أحدهم واحدا من الأنصار وفيه تعريض لاتخاذهم آلهة من دونه سبحانه وتعالى وبأنها غير قادرة على نصرهم وتهكم بهم. اهـ.
|